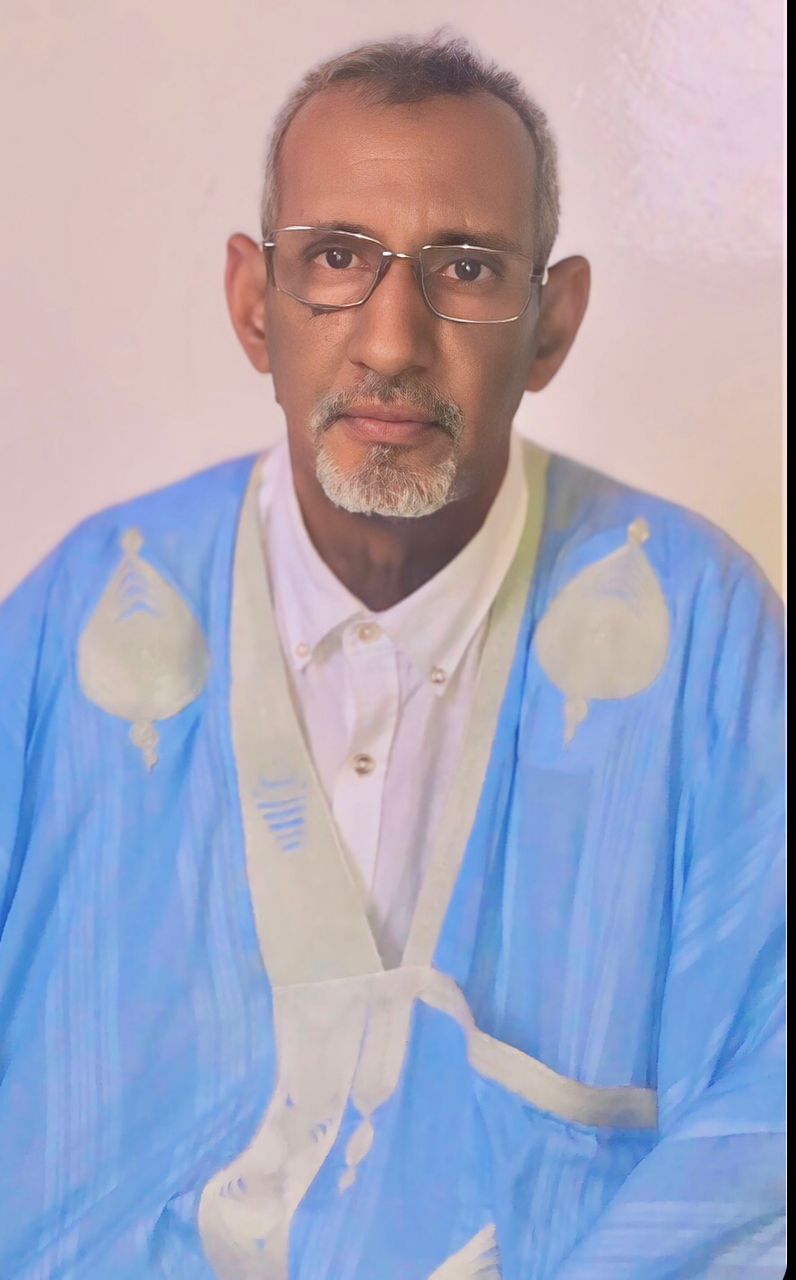أخبار اليوم. تشهد الساحة السياسية الموريتانية منذ نهاية السنة الأولى من المأمورية الأخيرة للرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني حراكًا سياسيًا لافتًا، تجلى في تصاعد الحديث عن الترشحات المبكرة للانتخابات الرئاسية المرتقبة. هذه الظاهرة تطرح إشكاليات تتجاوز الطابع الانتخابي الظاهري، لتغوص في عمق بنية النظام السياسي والاجتماعي القائم: هل نحن أمام استفتاء داخلي في أوساط السلطة لاختيار من يخلف الرئيس ضمن معادلة “الاستمرارية”؟ أم أن هذه الترشحات تعكس صراع أجنحة حقيقي داخل منظومة حكم تنوء بتناقضات متراكمة منذ الاستقلال؟
1. بنية النظام السياسي وتحالف القوى التقليدية
منذ لحظة الاستقلال الشكلي سنة 1960، ظلت السلطة الفعلية في موريتانيا محتكرة ضمن تحالف ثلاثي مركب يجمع بين المؤسسة العسكرية، والزعامات القبلية، ورجال المال. هذا التحالف – المتجذر في الحقبة الاستعمارية – يمثل ما يمكن وصفه بـ”الأوليغارشية الحاكمة”، وهي طغمة وظيفية تكرّس سيطرتها على الدولة عبر احتكار الثروة والسلطة، وإقصاء الفئات الهشة والشرائح الشعبية من دوائر التأثير.
تعود جذور هذه المنظومة إلى الاستعمار الفرنسي، حينما عملت الإدارة الكولونيالية على إعداد طبقة من “الوسطاء المحليين” في مدينة سينلوي السنغالية، جرى توظيفهم كمترجمين وموظفين في الإدارة، وفق مناهج تضمن ولاءهم. ومع الاستقلال، ورثت هذه الفئة أدوات السلطة، وحافظت على روابطها البنيوية مع الأسس الثقافية والسياسية التي أرساها المستعمر.
2. مأمورية غزواني: الاستقرار الظاهري وتصدعات العمق
على الرغم من أن الرئيس محمد ولد الغزواني قدم نفسه كرجل توافق وهدوء، يسعى إلى تجاوز الاحتقان السياسي، إلا أن مأموريته كشفت عن استمرار البنية العميقة نفسها التي حكمت البلاد لعقود. فقد بدا واضحًا أن محاولة التوفيق بين مراكز القوى داخل النظام – من عسكريين ورجال أعمال وزعامات قبلية – أدت إلى إنتاج نوع من “الجمود المُزَخرَف”، حيث تُرفَع شعارات الإصلاح دون قدرة حقيقية على التنفيذ.
وفي هذا السياق، بدأت بعض الشخصيات المحسوبة على مراكز النفوذ في الدفع بترشحات مبكرة، إمّا في إطار ما يشبه الاستفتاء الداخلي لاختبار المرشحين، أو ضمن معركة معلنة على الخلافة بين أجنحة السلطة.
3. الانتخابات القادمة: تجاذب الأجنحة أم إعادة توزيع النفوذ؟
تُفهم الترشحات الرئاسية المبكرة داخل هذا السياق كنمط من “الصراع النخبوي” المغلق، حيث يتنافس أبناء المنظومة نفسها على وراثة مركز القرار، وليس على تغيير السياسات أو بنيات الحكم. هذا النمط يعكس استمرار ذهنية “التعيين بالتزكية”، حيث لا تزال الثقافة السياسية في مستوياتها العليا أسيرة منطق التوافق داخل الدوائر الضيقة، لا التنافس عبر المؤسسات الديمقراطية الفعلية.
ويُخشى أن تتحول هذه الترشحات إلى آلية لإعادة تدوير النخب ذاتها، عبر توزيع الأدوار داخل التحالف القائم، لا سيما في ظل غياب إعلام حر، وضعف مؤسسات الرقابة، وهشاشة المشهد الحزبي.
4. التعليم والفساد: أدوات التوريث والإقصاء
من أبرز تجليات خلل النظام القائم، ما لحق بقطاع التعليم من تدهور ممنهج خلال العقود الماضية. فبدلًا من أن يكون التعليم أداة للترقي الاجتماعي وتحقيق العدالة، تحول إلى وسيلة لإعادة إنتاج التهميش، عبر تعيينات لا تخضع لمعايير الكفاءة، وتفريغ المناهج من مضامينها النقدية والتنويرية، وتفشي الرداءة الإدارية والتربوية.
لقد ساهم هذا الانهيار المتعمد في خنق تطلعات الفئات الشعبية، وقطع الطريق أمامها نحو الوظائف الحيوية، ليظل الولوج إلى المناصب السامية حكرًا على أبناء النخبة العسكرية والقبلية والمالية، ضمن منطق قائم على الامتيازات والولاءات، لا الاستحقاق.
5. هل من أفق للقطيعة والتحول؟
رغم سطوة هذه المنظومة، وتغلغلها في مفاصل الدولة والمجتمع، فإن الأمل في التغيير يظل قائمًا، خاصة مع بروز فئات شبابية ومجتمعية بدأت تطالب بقطيعة فعلية مع هذا النموذج، وبتأسيس دولة المواطنة والعدالة والكفاءة.
وتبقى فرضية التحول رهينة بعدة عوامل متداخلة:
مدى تصدع تماسك الجبهة الداخلية للنظام.
بروز مرشح من خارج الدائرة التقليدية، يتمتع بشرعية شعبية وكفاءة إصلاحية.
تطور وعي شعبي رافض للوصاية القبلية والعسكرية.
انفتاح السياقين الإقليمي والدولي على دعم انتقال حقيقي نحو الديمقراطية.
خاتمة
الترشحات المبكرة في موريتانيا ليست مجرد تحضيرات لانتخابات قادمة، بل هي مرآة تعكس ديناميات السلطة وصراعاتها البنيوية. وخهي تكشف في الوقت ذاته عن مأزق النظام القائم، الذي يسعى إلى التجدد من داخله دون المساس بجوهره، عبر استبدال الأوجه مع الحفاظ على البنية. في المقابل، فإن التغيير الحقيقي يظل مرهونًا بمدى قدرة الفئات المهمشة والمجتمع المدني والقوى الوطنية المستقلة على فرض قطيعة حقيقية مع هذا المسار، وفتح أفق جديد للدولة الموريتانية الحديثة.